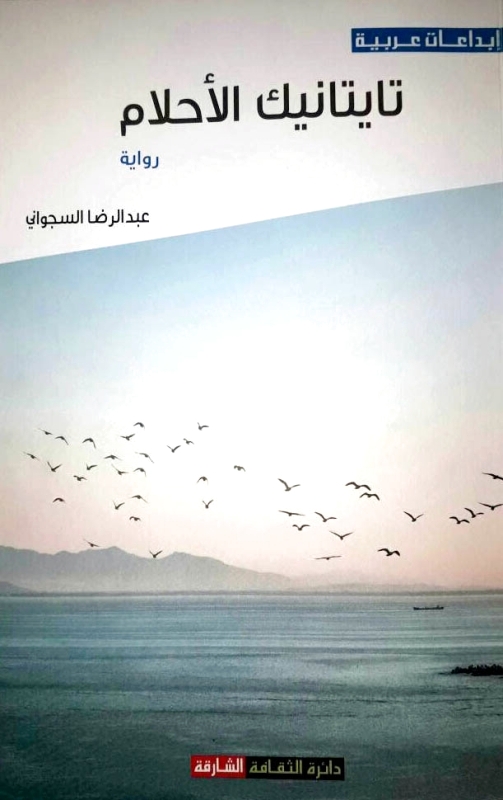منذ أن تفتح وعيه على دنياه الصغيرة وهاجس سفينة «دارا» يؤرقه ويشجيه، لينطلق في مشوار امتد لأكثر من 7 سنوات في كتابة روايته «تايتانيك الأحلام»، عن السفينة التي احترقت وغرقت عام 1961 فاستقرت في قاع الخليج العربي وبلغ عدد ضحاياها 238 راكباً من رجال ونساء وأطفال، وقد ظلت دموع الألم والحسرة ترافقه طوال فترة كتابة العمل.
إنه الكاتب والأديب عبد الرضا السجواني، الذي عشق البحر وسفنه، فوجد نفسه يبحر في عمق هذه الحادثة الأليمة التي لم تكن في الحسبان على الإطلاق، ولم تخطر على بال قبطان السفينة ولا مساعديه، ولا البحارة أو الركاب أو العاملين في الموانئ التي تتردد عليها، ولا من أي دولة تقع في الجوار.
وهو يحكي لـ«بيان الكتب» عن روايته وعن الحادثة.. حيث انهال سرده في الخصوص ككتلة من المشاعر، مبيناً أنه سخّر إبداعه الأدبي في كتابة رواية تنحاز لدبي قلباً وقالباً مستحضراً من قلب الوجع حكايا تستحق أن تُروى.
كما بين أنه يطمح إلى تحويل العمل إلى فيلم سينمائي على مستوى عالٍ، يضيف لكم الإنجازات التي حققتها الإمارات في مجالات الثقافة والفن والإبداع. كما يؤكد السجواني في الحوار إيمانه الثابت بأن البعد الإنساني مقياس تميز الرواية كونه يكسبها قيمة عالية.
«دارا» سفينة الأحلام، هي بطلة روايتك التي ارتبط بها الآباء والأجداد بعلاقة حب فريدة رغم ما تسببت به من ألم ووجع في نهاية المطاف، ما الذي دفعك للكتابة عنها رغم مرور أكثر من خمسة عقود من الزمان على غرقها، وما طبيعة العلاقة التي تربطك بها؟
اخترت «دارا» لتكون بطلة روايتي الأولى كونها لامست - وعن كثب - جزءاً مهماً وحساساً من ماضينا التليد، وكواقعة اهتز لها خليجنا العربي مروراً بالدول العربية، إضافةً للدول الأجنبية في سفن إنقاذها البريطانية والألمانية والإيطالية والنرويجية وغيرها، وأيضاً لتأثير الواقعة الكبير على الناس رغم مرور سنوات طوال عليها، إذ لا تزال عبارات التأبين والحسرة على ضحاياها الكثر تتردد وتتناهى إلى مسامعي حتى اليوم، وكان من ضمن الضحايا ابن عمي الذي يحمل نفس اسمي.
بالإضافة إلى عشقي للبحر وسفنه الكبيرة، وتعدد المرات التي استقل فيها السفن من بلد إلى آخر عبر البحار والأنهار والبحيرات الشاسعة، إلى جانب مشاهدتي لفيلم «تايتانيك» الشهير وبحثي عن أفلام أخرى تتناول عوالم السفن والبحار والأنهار، ليتمخض عن هذا العشق روايتي «تايتانيك الأحلام».
استغرق عملك على هذه الرواية 7 سنوات، عملتَ خلالها ليل نهار بحثاً ونبشاً وتخييلاً، ما الذي كشفته لك سنوات العمل السبع، وما الذي جددته في داخلك من مشاعر وانفعالات؟
جاءت روايتي هذه بعد تسع مجموعات قصصية، وثلاثة إصدارات موجهة للأطفال وغيرها، وكونها أولى رواياتي في الساحة الثقافية، راعيتُ التمسك بعدة اعتبارات وأسس لبلورة دوري وواقعي الذي يجب أن أكون عليه أمام تاريخ حافل وأحداث جسيمة، وقصص وحكايات متعلقة بالبحر وبسفينة «دارا» بعد احتراقها وغرقها، ولذا، وظفت كل إمكاناتي الإبداعية واللغوية ومهاراتي المتراكمة في القص بالبحث والتنقيب والجري المتواصل، بغية خلق عالمي الذي أريد وأقتنع، وقد كان التعب والسهر والدموع رفاقي في رحلة كتابتي للرواية، لما سمعته من قصص وحكايات مؤلمة جداً للناجين أو أهاليهم أو من المنقذين.
حدثت فعلاً
تتضمن روايتك 3 فصول تغلغلتَ من خلالها إلى حياة الناس، وعرجتَ على مشاعرهم وطرائفهم وحكاياهم، هل كان وصفك واقعاً ملموساً عشته، أم استعنتَ بالخيال في أماكن كثيرة لتعزيز حضور المشهد؟
عبر فصول روايتي كانت الأحداث والحكايات والقصص سواء على مستوى الأحياء المطلة على البحر في الشارقة ودبي، وغيرهما، قد حدثت فعلاً بمستوى 80% وإن استعنت بعنصر التخييل الذي لا مناص من الانقياد نحوه عند الأديب، وقد استغرقت في عملية بحثي وتوثيقي لتلك الأحداث والقصص قرابة ثلاث سنوات ونصف، ليتكوم أمامي حشد من الأوراق والتقارير والترجمات وغيرها، لأبدأ العمل عليها بعدها.
وصفتَ السفينة «دارا» وصفاً دقيقاً، وكأنها حاضرةٌ أمامك، كيف توصلت لكل هذه التفاصيل؟
وصفي للسفينة في الفصل الثالث وبالتحديد من الداخل عبر أروقتها وممراتها وصالاتها وطوابقها وكل ما تعلق بها، جاء متمخضاً عن ملاحقتي الحثيثة لمرتاديها من كبار السن من أهالي الإمارات والتجار، كما جاءت تلك الدقة ترجمةً لولعي الكبير بالسفن منذ استقليت سفينة إيروس عام 1979..إلى جانب الاستعانة بمخيلتي، والوثائق التي كانت تبين العديد من التفاصيل في هذا الخصوص.
مشاعر وعواطف
نلحظ في الرواية طغيان المعالجة الإنسانية بشكل أكبر من التقديم الوثائقي للحدث، لأي مدى استعنتَ بالوثائق «البريطانية مثلاً» في روايتك هذه، وهل ترى أن قيمة رواية كهذه تكمن في الجانب الإنساني أم الوثائقي؟
قيمة روايتي وأي رواية أخرى تكمن في البعد الإنساني الذي ينتهجه الأديب، وبما تجود به قريحته من مشاعر وعواطف والكثير من التأثر، كيف لا وأنا لم أزل حتى الآن أتألم ويتداخلني شعور من الضيق والأسف على ما سمعته ورأيته عبر التقنيات الحديثة من وقائع مؤلمة فعلاً، فالجانب الإنساني المفعم بتلك الأحاسيس الجياشة هو ما يحفز الأديب على الإنتاجية الجادة والفاعلة، في حين أن اطلاعي على الوثائق البريطانية كان بمثابة شاهد عيان على أغلب ما وقع على متن سفينة «دارا»، والقيمة الإنسانية في الرواية تتجسد بالوقفات الحقيقية للركاب من الناجين وأقربائهم، وما آلت إليه الأمور قبل وبعد الكارثة، خاصة بعد عمليات الإنقاذ، فالمتابعون لهذه الحادثة يعرفون المواقف الإنسانية والنبيلة للمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، الذي أعطى أوامره الفورية بإرسال طبيب إلى السفينة المنكوبة، واستقبال المصابين في مستشفى المكتوم، وذكروا لنا أن «فرضة» خور دبي عجت يومها بالمصابين المتوزعين على الرصيف تمهيداً لنقلهم إلى المستشفى، وظل المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، متابعاً لمجريات الحادث حتى إجلاء آخر مصاب وراكب متفقداً المصابين وأحوال الناجين الذين عادوا لبيوتهم.
هدف
تمتلك رغبة جادة في توصيل قصة «دارا» إلى العالم، هل ترى بأنها يمكن أن تنافس قصة الفيلم الهوليوودي الشهير «تايتانيك» بحجم الألم، وبروعة تصوير التفاصيل كما رأيناها في العمل السينمائي؟
من ضمن أهدافي الرئيسة من إصدار الرواية، أن أهتف بأعلى صوتي أن الإمارات بإمكانها، بل أن الريادة والإمكانيات متاحة لها، بأن تتألق بفيلم سينمائي يتناول كل المعايير العالمية، من خلال عمل يمتلك ذات الولع والطرح والتألق الذي شاهدناه في فيلم «تايتانيك».
وذلك باتباع منهجية وأسس وقواعد ثابتة وقويمة لخلق هذا الفيلم المرتقب من خلال احتراق وغرق سفينة «دارا» التي أطلق عليها صحفيو بريطانيا في اليوم التالي من غرقها صبيحة 9 أبريل 1961 عناوين لافتة كـ(تايتانيك الخليج)، وجاءت هذه التسمية - وفقاً للوثائق - لفداحة ما وقع على متنها وللأعداد الكبيرة من الضحايا والمفقودين.
ما الذي سيضيفه تحويل روايتك إلى فيلم سينمائي للساحة الفنية والإبداعية الإماراتية؟
أطمح بكل عزم وجدية لتحويل روايتي بآلية ناجحة إلى فيلم سينمائي، كإنجاز جديد في هذا المجال لرفعة دولتي الإمارات، علني أتمكن من تقديم شيء يسير يساهم في تألقها بعد خمسة عقود من الزمان قضيتها في شأن الكتابة الإبداعية، وقد بلغت من عمري الستين عاماً، وفي مسيرة كتابتي لهذه الرواية كنت مهندساً إياها لأن تكون رواية الإمارات المتألقة، وإن تحقق هذا الحلم، فإنه سيضيف إلى رصيد الإمارات الفني والابداعي الشيء الكثير.
«تايتانيك الأحلام».. حكايات حب بين غرق واحتراق
«وإن كنت أخصه قبل مهجتي.. للذي أهفو متلظياً.. غارقاً في حنيني.. وعلى نعش وجودي.. إلا أن ضحايا سفينية «دارا» ومن ضمنهم ابن عمي الذي اسمه هو اسمي، هم من عنيتهم بكياني وروحي».
بهذه الكلمات بدأت رواية «تايتانيك الأحلام» للأديب عبد الرضا السجواني، والصادرة عن دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، لتسلط الأضواء على مجمل تفاصيل وملابسات احتراق وغرق سفينة دارا، التي بلغ عدد ضحاياها أكثر من مئتي شخص.
إذ إنها تكشف بأسلوب أنيق ومفردات منتقاة بعناية، حجم الوجع الذي يعتصر قلب الكاتب، ليوصل للقارئ واقعة أليمة بكل تفاصيلها، وبنكهة إنسانية خالصة، تتداخل معها 5 قصص حب تحاكي واقع الحال المجبول على الرومانسية المغرقة في الحي القديم في الإمارات والخليج العربي بشكل عام، لتحمل كل قصة باقات من أحلام تُحلق فوق سفينة الأحلام التي غرقت واحترقت، فإلى ماذا آلت إليه تلك الأحلام؟!
3 فصول
تتكون رواية «تايتانيك الأحلام» من ثلاثة فصول، حمل أولها عنوان «مرج الدانات» وقدم خلاله الكاتب وصفاً دقيقاً وجاذباً للحياة إبان واقعة السفينة «دارا»، وذلك من خلال المواقف والمستجدات من حي المريجة والأحياء الأخرى في الشارقة القديمة وفي دبي، مروراً بالاستعدادات للالتحاق بالسفينة في الفصل الثاني الذي حمل عنوان «ضفاف الوداع»، ووصولاً إلى مثوى السفينة ولهفة الركاب لبلوغ عوالمها المتفردة، وتطور الحدث كواقعة مهمة على ظهر السفينة في الفصل الثالث الذي حمل عنوان «أحلام ورماد».
ويمتلئ الفصل الثالث عن آخره بالألم والوجع، فالأحلام تتبخر، والحرائق تشتعل، والصراخ يتعالى، والكاتب في غمرة، كل ذلك ينهمر كالمطر في وصف قصص الفقد بين غريق وحريق.
واستغرق الكاتب عبد الرضا السجواني أكثر من 7 سنوات في كتابة روايته، وذلك لما تتضمنه من تأريخ وتوثيق للحياة في السابق، في ضوء حادثة «دارا».