لم يعد هناك من ينكر أن الديمقراطية معرضة للخطر في الكثير من أنحاء العالم المتقدم، إذ يشكك كثير من الناس في ما إذا كانت الديمقراطية تعمل لصالحهم، أو أنها تعمل بشكل صحيح أصلاً. ولا يبدو أن الانتخابات تسفر عن نتائج حقيقية، باستثناء تعميق التصدعات السياسية، والاجتماعية القائمة. إن أزمة الديمقراطية هي، إلى حد كبير، أزمة تمثيل، أو بتعبير أدق، غياب تمثيل.
وكانت الانتخابات الأخيرة في إسبانيا، على سبيل المثال، غير حاسمة ومحبِطة. وتتخبط دول كثيرة، تعد معقل الديمقراطية في العالم منذ أزل، في أزمات دستورية، بسبب انتخابات محددة من قبل أقلية من الناخبين.
و إن الأحزاب الإقليمية فقط - الحزب الوطني الأسكتلندي، وحزب Plaid Cymru (بليد كامري) في ويلز، والحزب الاتحادي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية، هي التي تتحلى بالمصداقية. وفي ألمانيا، أصبح «التحالف الكبير» المنهك، على ما يبدو، مصدراً لخيبة أمل متزايدة.
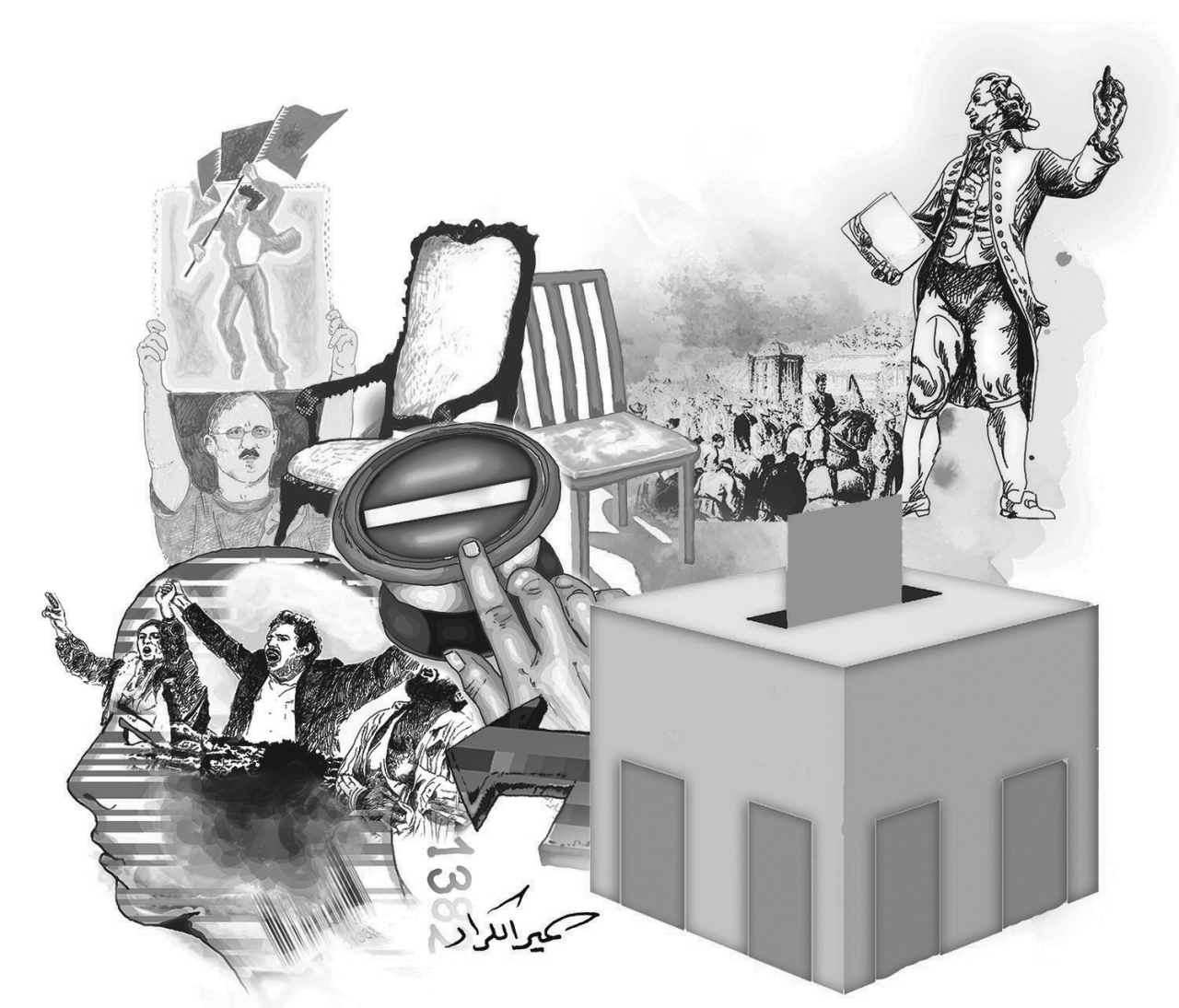
وبالنسبة للعديد من المعلقين، فإن التعب الديمقراطي الراهن يشبه بشكل مخيف، ما حدث في السنوات ما بين الحربين العالميتين، ولكنّ هناك فرقاً واضحاً، وهو أن أزمة الديمقراطية السابقة كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالبؤس الاقتصادي الذي سببه الكساد الكبير، في حين أن الأزمة الراهنة حدثت في وقت يشهد مستويات عالية من العمالة، لم يشهدها التاريخ من قبل. ومع أن الكثير من الناس، اليوم، يشعرون بعدم الأمان الاقتصادي، فإن الاستجابة للأزمة الحالية لا يمكن أن تكون مجرد تكرار لما حدث من قبل.
إذ خلال سنوات ما بين الحربين العالميتين، أعيد تشكيل الحوكمة الديمقراطية في كثير من الأحيان، لتشمل أشكالاً مختلفة من التمثيل. وكانت أكثرها جاذبية في ذلك الوقت هي النقابوية، حيث تفاوضت مجموعات، لديها مصالح ومنظمة رسمياً، مع الحكومة نيابة عن مهنة ما، أو قطاع اقتصادي معين. وكان متوقعاً أن تكون مجموعات العاملين في المصانع، والمزارعين، وحتى أرباب العمل أكثر قدرة على التوصل إلى قرارات من المجالس التمثيلية المنتخبة، والتي أصبح ينظر إليها على أنها مرهقة، وتمزقها الانقسامات السياسية المستعصية.
ويبدو نموذج النقابوية ما بين الحربين العالميتين بغيضاً الآن، خاصة لأنه ارتبط بالدكتاتور الفاشي الإيطالي، بينيتو موسوليني، ومع ذلك ولبعض الوقت، جذب أسلوب موسوليني السياسيين في أماكن أخرى، بمن فيهم أولئك الذين لم يروا أنهم يحتلون أقصى التطرف السياسي.
بسبب الإخفاقات الكارثية للديمقراطية في الكثير من الدول المتقدمة بعالمنا، أصبحت الديمقراطية في حقبة ما بعد الحرب مقيدة بالحدود الدستورية والقانونية المحلية الجديدة، وبالالتزامات الدولية. وبالنسبة لأوروبا القارية واليابان، فُرضت الديمقراطية، إلى حد كبير، جراء الهزيمة العسكرية، ما يعني أن قواعدها وضعت من الخارج، ولم تخضع لأي تحدٍ رسمي. وبعد ذلك، ظهر التكامل الأوروبي، في شكل الجماعة الاقتصادية الأوروبية، ثم في شكل الاتحاد الأوروبي، بصفته نظاماً للحكم والإنفاذ، يخدم المعايير المعمول بها. وعلى نطاق أوسع، أصبحت الاتفاقات الدولية وسيلة لتوضيح أن بعض القواعد غير قابلة للكسر، أو أنه لا سبيل للهروب منها، ولم يعد من الممكن الطعن فيها ديمقراطياً، أو غير ذلك.
وزادت الاعتبارات العسكرية، بالطبع، من هذه القيود القانونية الجديدة، وكانت التحالفات الدولية وسيلة للحفاظ على الأمن الداخلي. وكان المقصود من حلف الناتو، على حد تعبير أمينه العام الأول، اللورد إيسماي، «إبعاد الروس، وإبقاء الأمريكيين في الداخل، وإبقاء الألمان تحت السيطرة».
وكان هذا الترتيب الناجح، والفريد من نوعه، الذي كان يهدف لضمان الاستقرار بعد الحرب، يتفكك حتى قبل التراجع المفاجئ لشرعية الولايات المتحدة، بعد حرب العراق عام 2003، والأزمة المالية العالمية، للفترة ما بين 2007 و2008. وعندما استخدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الآونة الأخيرة، لغة متطرفة لوصف الاتحاد الأوروبي بأنه يقف «على حافة الهاوية»، ووصف حلف شمال الأطلسي بـ«الميت دماغياً»، كان دقيقاً تماماً.
وكثيراً ما تعرض نظام ما بعد الحرب لانتقادات، لعدم قبوله أي خيار ديمقراطي حقيقي. وبناءً على ذلك، بدأ علماء السياسة الغربيون يتحدثون عن التسريح على نطاق واسع. وقبل ظهور اليمين الراديكالي الألماني الجديد بوقت طويل، توصل مفكرون ألمان بارزون إلى أن التصويت لم يكن مهماً، وأن الحداثة هي الحكم من قبل المعتدلين المقيدين ذاتياً نيابة عن مشلولي الحركة - «الخمول».
والتحدي الحديث، إذن، هو تحقيق قدر أكبر من الشمولية الديمقراطية. ولا يمكن أن يكون النظام النقابوي القديم هو الحل، لأن غالبية الناس لم تعد تحدد هويتها بمهنة واحدة، بل ولا تشغل المهنة حيزاً كبيراً في تلك الهوية. وكذلك، فإن الحجة الداعية إلى وجود تكنوقراطية دولية قائمة على القواعد تبدو الآن متعبة وكسولة، مع أن المؤسسات الدولية (بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وحتى الناتو)، لا تزال ضرورية لتوفير السلع العامة.
وفي الوقت الراهن، تُحَدَّد الهوية الشخصية بمجموعة معقدة من العوامل. ويرى معظم الناس أنفسهم مستهلكين، ومنتجين، وعشاقاً، وأولياء أمور، ومواطنين، ومتنفسين لنفس الهواء، حسب السياق. وهناك حاجة إلى خيارات تتكرر أكثر، ومحددة بوضوح، لترجمة تعقيدات الذات إلى تعبير سياسي.
ولِحُسن الحظ، يمكن أن تساعد التقنيات الحالية في ذلك، إذ تعد المواطنة الرقمية - عن طريق التصويت الإلكتروني، والاقتراع والالتماس - أحد الحلول الواضحة لمشكلة تراجع المشاركة. وبالطبع، من المهم أن نفكر ملياً بشأن القرارات التي نخضِعها لأساليب التداول والتصويت الجديدة، والمباشرة. ولا ينبغي أن تستخدم هذه الآليات في الخيارات الرئيسية المحددة، التي تعتبر بطبيعتها مثيرة للجدل، والخلاف، ولكن يمكنها المساعدة في المزيد من القضايا اليومية، والعملية، مثل موقع نظام السكك الحديدية، أو الطرق، أو تفاصيل التحكم في الانبعاثات، وأسعار الطاقة.
وستعمل رؤية التجديد الديمقراطي هذه بشكل أكثر فاعلية، في الدول الأصغر مثل إستونيا، التي كانت رائدة في المواطنة الرقمية، والإقامة الإلكترونية. ويمكن للمدن الفردية أن تفعل الشيء نفسه، ومن ثم تقديم دروس لحكومات أكبر. وقد يكون التفكير محلياً في مشكلة التمثيل، هو الخطوة الأولى نحو التغلب على أزمة الديمقراطية على الصعيد العالمي.
ـــ أستاذ التاريخ والشؤون الدولية بجامعة برينستون، وزميل أقدم في مركز الابتكار في مجال الحوكمة الدولية
opinion@albayan.ae

