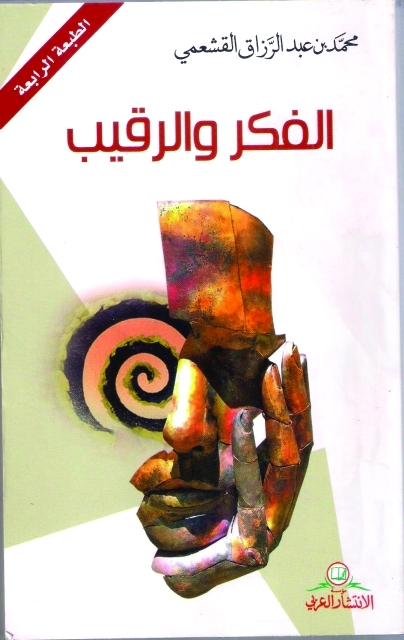يستهل كتاب الفكر والرقيب، لمؤلفه محمد القشعمي، موضوعات دراساته ببحث خاص في الفصل الأول يمثل نبذة موجزة عن حرية الرأي والتعبير، مُعرفاً الرقابة ومبيناً أشكالها والمبررات التي تدفع الدول النامية إلى فرض الرقابة على الحريات بأنواعها، لتطال الكتب والصحف والمجلات والأفلام وبرامج الإذاعة والتلفاز.. وعلى ما يُلقى من خُطب.
ويلفت القشعمي إلى أن الإسلام كفل مبدأ الحرية كأصل عام، قبل أن بتطرّق إليها المشرعون وفقهاء القانون، لوضعها في قوانين ودساتير عالمية. ويستشهد بالعديد من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تثبتُ صحة ذلك.
وبرأي مُعظم المؤرخين، كما يشير المؤلف، فإن الرقابة على الإنتاج الفكري قديمة قدم الطباعة، وهي تعود في أوروبا إلى بدايات القرن السادس عشر.
وبدا لافتاً الرقابة الصارمة التي فرضتها الكنيسة في ذلك العهد على كل المنشورات التي كانت تحتاج إلى الإذن لتحظى بحق النشر. وهذا ما يُفسّر سيادة الجهل والظلام في أوروبا، قبل أن تسقط السلطات الملكية التي كانت تحكم باسم «الحق الإلهي».. ومن ثم يستلم الشعب الحكم عبر برلمانات ديموقراطية منتخبة.
ويحدد الكاتب نوعين من أشكال الرقابة: أولهما الرقابة المنظورة أو المباشرة، وهي تكون سابقة للنشر أو بعده أو قبل التوزيع، وتجسد نمط رقابة إدارية تعمل على مراقبة المنشورات قبل طباعتها أو منع توزيع أعدادها.
وثانيهما الرقابة غير المنظورة أو غير المباشرة، وتأخذ عدة أنماط كإصدار قائمة التعليمات أو التوجيهات الحكومية حول بعض المحظورات الخاصة بالنشر، أو التدخل في أسلوب معالجة الأحداث وصياغتها أو التعرض للإعلاميين والضغط عليهم..
ويؤكد القشعمي أن جميع الدساتير العربية تقول بمبدأ حريات الرأي والتعبير والطباعة والنشر، ويعطي أمثلة على ذلك مُستمدة من الدساتير العربية وقوانين المطبوعات في لبنان وقطر والمملكة العربية السعودية، إذ تكفل جميعها حرية الفكر والتعبير.
ويبين المؤلف في الفصل الثاني أن الرقابة في المملكة العربية السعودية أخذت تخفّ وطأتها بعض الشيء. وتوازي ذلك مع اتخاذ المملكة خطوات شتى في الخصوص، وكذا تطوير قوانين المطبوعات كي تُواكب العصر.
وبالنسبة للمعايير التي تفرضها الرقابة على المطبوعات، يذكر الكاتب بعضاً منها، مثل: ألاّ يتعارض المطبوع مع العقيدة الإسلامية، وألاّ يدعو إلى الإباحية وما يخدش الآداب العامة.. والأفكار والنظريات الهدامة المستوردة، وألا يؤدي إلى المساس بكرامة الأشخاص وحرياتهم أو الإضرار بسمعتهم.
ويُضمّن المؤلف الفصلين الثالث والرابع طرائف ونوادر أفرزتها الرقابة على الصحافة وانتهت بعزل مسؤولين.
ويُكرّس الفصل الخامس لعرض مفاعيل الرقابة في عصر الفضائيات والإنترنت. وفي هذا الصدد، يُشير إلى لجوء بعض الدول إلى وضع حظر كامل على أطباق استقبال الأقمار الصناعية، بحجة تجنب ما يمكن أن تقدمه من ثقافات فاسدة وغير أخلاقية.
لكن المخاوف عادت لتتصاعد مع ظهور الإنترنت. ويلفت الكتاب هنا إلى أنه يُجمع عدد من النقاد وأساتذة الإعلام في الجامعات السعودية على ضرورة التحصين الذاتي للأفراد، من أجل أن يقوم كل واحد بدور الرقيب، ويقف أمام المضامين الشاذة والقيم المستوردة التي لا تتفق مع ثقافتنا العربية والإسلامية.
إغراء الانفجار الإخباري والمعلوماتي على شبكة الإنترنت، كما تحلو التسمية للكاتب، لم يحل دون استخدام الحكومات على مستوى العالم كلّه، تكنولوجيا مُتطورة لتعديل مسار المعلومات أو حجبها أو التلاعب بها. وأُولى هذه المحاولات ظهرت في الولايات المتحدة الأميركية عندما جرى تقديم «مشروع القانون الفيدرالي للياقة والاتصالات الذي يُجرّم الاتصال المباشر..
والذي يمكن أن يُوصف بأنه فاحش أو خليع أو داعر أو بذيء وغير لائق ويستهدف مُضايقة أو تهديد أو التحرّش بشخص آخر، إذا كان دون الثامنة عشرة من عمره».
ويخلص الكاتب إلى القول إن شبكة الإنترنت تشكل أكبر تحدٍ للرقيب، وأنه من المستحيل وقف تدفق المعلومات أو فرض قيود صارمة عليها. وهذا ما يتيح لحرية الرأي والتعبير مساحات أوسع ستعجز الحكومات عن الوقوف في وجه المواطنين الراغبين في الاطلاع على خفايا الصحف، من دون حسيب أو رقيب.