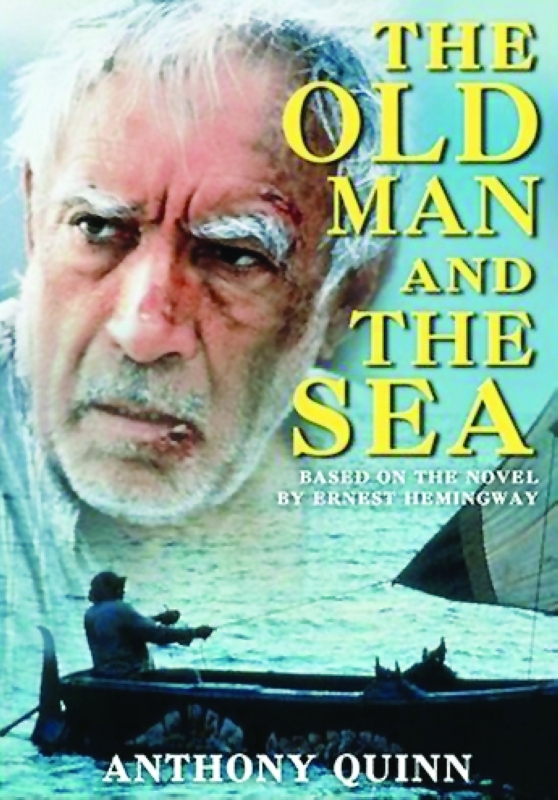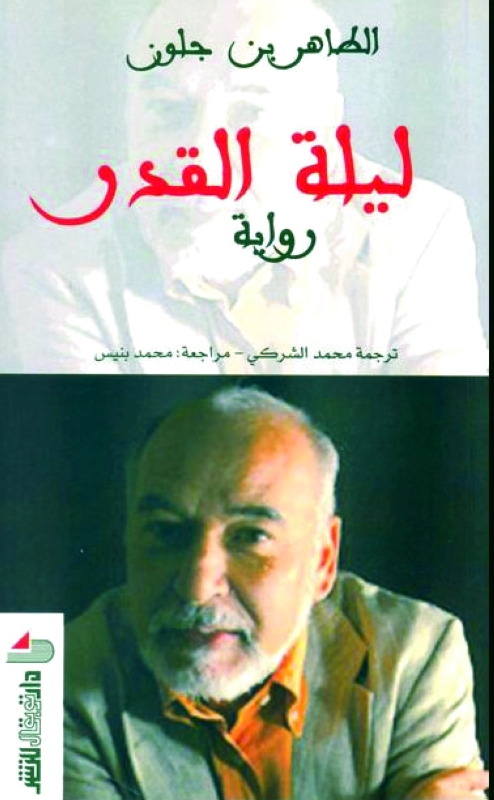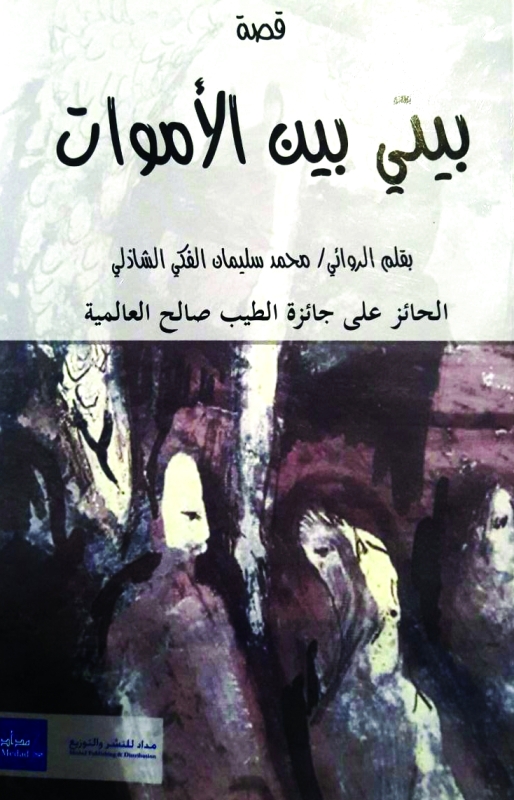ما لم ينطوِ السرد الحكائي على تنظيم فني واعٍ للأحدث، يرصد جملة من التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الكبرى التي يمر بها مجتمع كامل وواسع، على امتداد أجيال وعقود، بنفَس طويل تحليلي واستطرادي، في ظل تعدد الشخوص واستعراض تفاصيل المكان، فإننا إذاً لا نتحدث عن فن الرواية، لأن تلك هي أبرز ملامحها التي تقتضي أن يطول السرد فيبلغ مئات وربما آلاف الصفحات، إلى درجة تقسيم العمل إلى أجزاء أحياناً.
أما ما تزخر به الساحة الأدبية اليوم، على مدى الأفق العربي، في ظل ما تقدمه ثورة النشر أو ازدهار النشر والجوائز منذ بداية الألفية الثالثة، من تسهيلات وترويج ساعد على انتشارها، فهي ليست رواية بحال، وإنما هي في الغالب «نوفيلا»، والنوفيلا إنما هي قصة طويلة، أطول من القصة القصيرة، تجيء في حدود المئة صفحة، أبطالها قلة والمجتمع الذي تستعرضه وتعالج أحداثه محدود، قرية مثلاً أو أسرة، وتجري أحداثها في مدى زمني لا يتجاوز السنة أو القليل من السنوات فقط.
وبعد أن نسجل تساؤلنا واستغرابنا من تعامل النقاد ولجان الجوائز الأدبية بأريحية مع هذا الجنس الأدبي بوصفه رواية، فإننا نشير إلى أن هذا الملف سيستجلي العناصر المكونة لفن النوفيلا وجذوره التاريخية وسنستحضر الكتاب العالميين الذين تبنوه وحققوا به مواقع مرموقة في خارطة الأدب العالمي.
ولكن.. هل يتمتع أدباؤنا الجدد بوعي كاف تجاه شروط النوفيلا التي يقعون في أحضانها أشتاتاً؟ هل يكتبها الشباب وهم يعرفون جيداً أنها ليست مجرد قصة طويلة، وإنما لها أصول وشروط بنيوية وتيماتيكية، يجب الالتزام بها؟ أو تجاوزها عن دراية.
«البيان» في سياق مساهمتها في فحص ظواهر الساحة الثقافية، تطرح هذه المرة مسألة طغيان النوفيلا على المشهد الإبداعي الأدبي، وسبب شغف الشباب بها، حتى غصت الأرفف بهذا الإنتاج الذي يطلقون عليه رواية دون وجه حق، فما هو رأي أهل الثقافة إزاء ما يجري من افتتان بكائن جميل مجهول الاسم بين معظم عشاقه...
اعترافات ووصايا
الأديبة الإماراتية فتحية النمر تقر بفرضية تحقيقنا، تقول: نعم القصة الطويلة أو الرواية القصيرة هي الدارجة اليوم، والمنتشرة في الساحة الثقافية الإماراتية وغالباً ما تكون منتجة من قبل الكتاب الشباب، وهي في الأغلب تتراوح ما بين عشرين وثلاثين ألف كلمة، والملاحظ أنها هي التي يتم اختيارها للفوز بالجوائز، خاصة جائزة الرواية الإماراتية.
وتمضي فتحية في الاعتراف فتردف قائلة: أنا بدوري كتبت واحدة منها وربما اثنتين، وهي: السقوط إلى الأعلى وطائر الجمال. ورغم أن روايتي الأخيرة «سيف» الصادرة عن المصرية اللبنانية لا تتجاوز هذا العدد من الكلمات، لكنها لا تعتبر رواية قصيرة، بل هي رواية طويلة.
إذاً، ما الفرق بين النوعين؟ تسأل ثم تجيب: برأيي ليس عدد الكلمات أو عدد الصفحات هو الفيصل أو الحكم، إذ هناك أمر آخر أو شروط أخرى، وأظنها في الشخصيات.
ففي النمط الأول، النوفيلا، الشخصيات تكون محدودة للغاية، وربما اقتصرت على واحدة، وهي المحورية، وكل ما في الصفحات يدور حولها، هي الوحيدة البارزة، وهي التي تتكلم أو يتم الكلام عنها وباقي الشخصيات إذا وجدت، فإنها تكون باهتة، لا دور لها سوى مساعدة الشخصية المحورية لبلوغ الأهداف. وفي هذه النقطة تتفق الرواية القصيرة مع القصة القصيرة.
سمات
كما أن هناك نقاطاً أخرى تختلف فيها الرواية القصيرة عن الطويلة، وتتفق فيها مع القصة القصيرة، وهي محدودية الزمان والفضاء المكاني، فالمكان واحد أو اثنان على الأكثر، حيث لا تجد هناك تنويعاً في الأمكنة أو امتدادات، والحدث أيضاً يكون واحداً ونادراً ما ينمو ويتعرج ويتصارع حوله الشخوص المحدودون.
بالمختصر، الرواية القصيرة هي قصة قصيرة طويلة، إذا كانت القصة القصيرة تتراوح صفحاتها بين الأربع والعشر صفحات، والرواية القصيرة لا تزيد على 100 صفحة أو حتى لو زادت لا يمكن اعتبارها رواية طويلة لافتقارها للشروط الأخرى.
وأما لماذا النوفيلا دارجة وسائدة اليوم؟ فتبرر فتحية النمر ذلك بأن هناك خطة لتقديم الشباب وتمكينهم، وهؤلاء الشباب لا صبر لديهم ولا طول بال ولا رحابة.
هم هكذا سريعون، ويبغون المختصر والقصير، ولا وقت لديهم كما يقولون لقراءة رواية من 200 صفحة أو أكثر.
هناك أمر أخير أود قوله.. تقول فتحية: لا داعي للتمادي في كتابة هذا اللون من الروايات، انطلاقاً من مبرر أن القراء لا وقت لديهم للقراءة الطويلة، أو لأنها هي التي تفوز في المسابقات.
من يحب القراءة ومن يؤمن بجدواها ومن يعرف أنها حبل الخلاص الأخير والأقوى في العالم السائر بسرعة البرق نحو الهاوية، عليه أن يهرع للقراءة، أن يكون حذراً في الاختيار فيختار الأفضل لا الأقصر.
أما من يكتب فقط من أجل الجوائز فعليه ألا يكتب، فإن ذلك سيكون أفضل له وأشرف. لأن هناك أسباباً أخرى أكثر أهمية للاضطلاع بمسؤولية الكتابة، أسباب إنسانية لا تمثل الجائزة لها شيئاً.
انتحار للرواية
عمدة الرواية الإماراتية علي أبو الريش، له رأي إزاء ما يجري، يستهله بمقولة للسيد المسيح عليه السلام:
يقول يسوع، ما لم يولد الإنسان من جديد فلن يدخل ملكوت السماء. حاول بعض الكتاب أن يولدوا من جديد من خلال اختصار الزمن الروائي فاختصروا الحياة. وإذا كانت الرواية هي الحياة كونها حكاية الإنسان مع الوجود، وهي سؤاله الأول، من أنا؟ فالرواية لا تطرح عقيدة، ولا تقدم فلسفة وإنما تطرح الأسئلة وتحرض الإنسان كي يتخلص من إملاءاته ويصبح فارغاً ليدخل الضوء إلى داخله.
فالروائي لا يقدم لك القمر وإنما يشير إليه بإصبعه لتراه. إنه يفعل كما يفعل معلم البوذية مع مريديه. فالرواية تأملية خارج الأفكار وخارج الرواسب وفوق الأنا.
ويؤكد أبوالريش أن اختزال الرواية لم يأت سهواً وإنما هو نتيجة لخديعة عقل جبار وقع ضحيته كتاب لم تكتمل لديهم التجربة واعتقدوا أن الأمر بسيط جداً ويحق لهم أن يخوضوا التجربة من دون أي اعتبارات للشروط الواجب اتباعها حين الشروع في كتابة الرواية.
أبوالريش يعدد شروط الرواية، فيضيف: أول هذه الشروط أن الرواية ليست ومضة كالقصة القصيرة التي من شروطها التكثيف، واللعب على زمن اللحظة واعتماد الجملة القصيرة الدالة على حيز القصة المحدد وزمانها المرتبط بالمكان. وهذا فن رفيع له عباقرته من عملاق القصة القصيرة تشيخوف إلى يوسف إدريس.
ثم يدلف أبوالريش نحو النوفيلا ليقول: ما يطلق عليها القصة الطويلة تشبه الكائن المعاق غير مكتمل النمو. وهي تعبر عن الاستخفاف بالفن الروائي والعبث بوجدان الإنسان، كون الرواية هي التعبير المباشر عن هذا الوجدان. ولا نستغرب أبداً أن يحدث هذا، إذ أصبح الإنسان جزءاً من الآلة بل هو عبــد لها كما قال مارتن هايدجر في حديثه عن استيلاء الميكنة على الإنسان بعد تلاشي دور الرأسمالية في الغرب.
ويطل أبوالريش على المشهد المحلي فيقرر: في الإمارات انتشرت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة، نظراً لوجود عوامل مشجعة على الاستهلاك في كل شيء، وانعطف هذا على الرواية كونها أصل الحكاية والوشاية والغواية.
إلى جانب وجود النقد المدرسي الذي يغرف من بطون النظريات الجامدة ولا يعبأ بمطالب الروح. وهنا أركز على الروح، لأنها منبع الإبداع الحقيقي ومتى ما أقصيت الروح وبرز العقل تناثر الغبار وغطى سطح المرايا ولم يعد بإمكان الإنسان أن يرى نفسه. نحن بحاجة إلى مرايا كثيرة، وإلى فراغات واسعة في داخلنا كي نبحث عن الذات المغيبة ونسقط الضوء عليها. نحن بحاجة إلى الفراغ لنستدل على المعدن النفيس في داخلنا الذي شوهته النظريات، كما أننا بحاجة إلى إسكات الضجيج في داخلنا كما قال إيكهارت تول، والرواية وحدها القادرة على إخراجنا من الزيف الواقعي وإدخالنا في محيط اليقظة.
وكما يقول الحكيم أوشو: «ما من شيء يرهق الإنسان أكثر من الأقنعة»، والإنسانية بفعل الرواسب التاريخية لبست الكثير من الأقنعة تحاشياً لمشاعر الدونية والخوف من المجهول، ولا قوة في الأرض تستطيع أن تفشل هذه الخديعة غير الرواية، كونها برلماناً مفتوحاً وشخوصه أشبه بالفيلسوف العظيم فردريك نيتشه الذي فكك الذات البشرية إلى عناصر قوة متى ما اجتمعت انتصرت على البؤس والعدمية. من هنا نجد العدميين هربوا من الرواية إلى اللارواية خوفاً من اكتشاف عناصر القوة الضعيفة.
نسيج نوعين
أما الكاتبة الإماراتية باسمة يونس، فلها رأي متصالح مع الظاهرة، وتذهب إلى تسويغها والترحيب بها، حيث تعرّف النوفيلا بأنها قصة طويلة، وترتبط بالقصة القصيرة من ناحية، وتنسب إلى الرواية من ناحية أخرى، فكأنها نسيج من النوعين. وربما تكون النوفيلا بهذا التمازج أكثر الأنواع الأدبية مرونة وقدرة على التزاوج لإنجاب جنس أدبي يوضح نتائج هذا الاختلاط بين الأجناس وما يصنعه المزج بين عناصرها.
والنوفيلا تسمى الرواية القصيرة أو القصة الطويلة. أما الرواية فهي أطول أنواع القصص، وفيها الكثير من الأحداث التي تختلف بين ماض وحاضر وأحياناً مستقبل متخيل، والرواية تثير قضية أو عدة قضايا، وخلال سرد الأحداث ستكون هناك تفاصيل كثيرة ومختلفة، ويجب أن تكون مكتوبة بعناية وانسيابية، رغم كثرة الأحداث كي تبقي القارئ على اتصال مع الحدث الرئيسي وفي الوقت نفسه متشوقاً لمتابعة القراءة والوصول إلى النهاية.
وتضيف باسمة: القصة القصيرة فن نثري يعتمد في السرد على التكثيف ووحدة الموضوع ويمكن أن تكتب بشخصية واحدة أو باستدعاء عدة شخصيات، لكن أهم ما يميز القصة القصيرة، القدرة على تقديم موقف أو فكرة متكاملة بقليل من السطور وبلغة ذكية قادرة على تفسير الكثير ببضع كلمات وبقليل من التفاصيل، وبناء القصة القصيرة الفني يوضح كينونتها من أول سطر، لكن نجاح القصة وقدرتها على الوصول إلى القارئ يعتمد على رشاقة قلم الكاتب واختياره الكلمات التي سيحولها إلى هذا النص السردي.
وأما القصة القصيرة جداً فهي القصة الملخصة في سطرين أو أكثر قليلاً، لكنها لا تفقد فنياتها بغض النظر عن حجمها، وتحمل القصة القصيرة جداً بدورها رسالة، لكن كاتبها يكون شديد الوعي والعلم بأهم الكلمات وأقلها، والتي ستتمكن من شرح الحكاية من دون حاجة لسؤاله عما يعنيه من كتابتها وما غايته.
كل الأنواع السابقة في نظر باسمة يونس تتضمن أحداثاً وشخصيات وتعتمد على الحبكة الفنية القوية والزمان والمكان والحوار، لكن الحوار ليس ضرورياً، ويمكن في هذه الأيام أن يحصد الكاتب تميزه ونجاحه بكسر القوالب المعهودة والمعتادة في كتابة الأدب، لكنه يجب أن يكون متمكناً وذكياً بما فيه الكفاية ليفعل ذلك ويقدم على مخاطرة فيها الكثير من المجازفة بفشل العمل تماماً، إن لم يتمكن من تقديم قضيته بصورة مشوقة ولغة جذابة.
وعن المشهد الأدبي في الإمارات، تقول إنه حيوي ومتفاعل ويتناغم مع طموحات الجميع، وينسجم تماماً مع التطور الحضاري والمعماري، بل ربما يثير الدهشة أن يكون هناك هذا العدد والكم الكبير من الاهتمام بالكتابة والتأليف، وخصوصاً بين فئة الشباب ومن الجنسين، بعد أن سادت في العالم أجواء الترف الاقتصادي الذي جعل البعد عن الأدب أمراً محتوماً، مقابل هيمنة التكنولوجيا والأفكار التجارية والتوجهات العلمية أكثر.
وتعترف باسمة بأن كتابة النوفيلا هي الأكثر حضوراً على الساحة المحلية، وذلك بسبب كون غالبية الكتاب الشباب على وجه الخصوص يتطلعون إلى كتابة أعمال تجتذب أكبر عدد من القراء والمتابعين، وتهيمن عليهم فكرة كتابة عمل غريب ومبتكر سوف يحدث صدمة ويثير الدهشة من دون التفكير في الكيفية أو الأسلوب التقني المبتكر والذي يمكن أن يحدث بهذا العمل الأدبي صدمة ودهشة وحضوراً متميزاً، وتختم باسمة مداخلتها بملاحظة أن معظم الكتاب يعتقدون أن تقليل عدد الصفحات وكتابة الرواية القصيرة أو القصة الطويلة، سوف يحظى بالعدد المطلوب من القراء والمعجبين، لكن الحقيقة في عالم الأدب تقول دائماً إن عدد الصفحات لا يلعب دوراً في إنجاح أو فشل أي عمل، فقصة قصيرة أو أخرى قصيرة جداً من سطر أو سطرين يمكن أن تتفوق على رواية طويلة من مئات الصفحات وتغلبها بالشهرة وحصد اعتراف القراء بها، لكن لا شك في أن هناك روايات طويلة، تحمل قضايا مهمة وتنبش في أعماق الإنسان والمجتمع كي تستخرج أحداثاً وشخصيات ومواقف، تفاجئ القارئ وتطلعه على أشياء كان لا يدري بها وغمضت عليه، ومثل هذه الأعمال تستحق الإشادة، طالت أو قصرت، ولها مكانتها بين بقية الأعمال، سواء أكانت مكتوبة بطريقة مبتكرة أو من دون تخليها عن تقنيات وتقاليد كتابة الرواية أو حتى القصة المعروفة.
محل خلاف
الأديب الفلسطيني أنور الخطيب يبدأ فوراً بالإشارة إلى أن المصطلح غير متفق عليه من حيث التعريف والمعايير والمواصفات في الآداب الأجنبية الأخرى، ولا حتى في الثقافة الإيطالية التي صدرت عنها كلمة «نوفيلا»، وبشكل عام، هناك من يعتبرها أكبر من القصة القصيرة وأصغر من الرواية، في الوقت الذي يحدد البعض حجمها لتتراوح بين 17 ألف كلمة و40 ألفاً، أما من حيث المضمون فهي إما هزلية أو سياسية أو عاطفية، والبعض يضيف إليها عنصر الخيال والفنتازيا ليصبح جزءاً من التعريف والتصنيف، في الوقت الذي تعرفها دائرة المعارف البريطانية بأنها «سرد قصير محكم».
ولو عدنا إلى الأصناف الأدبية الغربية نجد أن القصة القصيرة كانت تُكتب في صفحات قد تصل إلى ثلاثين أو أربعين صفحة، ولو نُقلت إلى اللغة العربية لتحولت إلى ثمانين صفحة، علماً أن هناك أعمالاً أدبية في المكتبات العربية مصنفة على أنها رواية، لا تتجاوز ثمانين صفحة.
في كل الأحوال، لم تعد القصة القصيرة الغربية تُكتب في صفحات طويلة، بل انكمشت إلى عشر صفحات أو أقل، بينما تصل عدد صفحات الروايات إلى ثلاثمئة صفحة وأحياناً ألف صفحة، وهو ما لم يتوافر في الرواية العربية حتى الآن.
التصنيفات الأدبية مربكة بعض الشيء ولكنها ليست حاسمة، فحين يتم تصنيف عمل مثل «مزرعة الحيوانات» لجورج أورويل على أنه نوفيلا، وكذلك الأمر بالنسبة لرواية «العجوز والبحر» لآرنست همنغواي، نجد أنفسنا أمام كم هائل من الأعمال الأدبية التي كنا نعتقدها روايات، بينما هي «نوفيلا».
لا يوجد في اللغة العربية ما يقابل النوفيلا، أي قصة طويلة أو رواية قصيرة، رغم أن البعض، وهو قليل، أطلق على كتاباته «قصة أشبه بالرواية!» وهو تعريف ملتبس لا يدخل في التصنيف القصصي ولا الروائي، على الرغم من اختلاف معايير القصة عن الرواية.
ولو طبقنا المفاهيم غير العربية على أدبنا، فإننا لن نجد لدينا روايات على الإطلاق وإنما قصصاً طويلة، وأحياناً قصصاً قصيرة وفق حجم القصة التي كانت تُكتب قبل ستين سنة في بريطانيا وأميركا على سبيل المثال، ولا شك أن روايات «من عشاق الليدي تشاترلي» و«أبناء وآباء» للبريطاني ديفيد هربرت لونس، لن تكون روايات، لأن حجمها لا يتناسب وحجم الرواية التقليدية السائد. وربما أيضاً تم إلغاء عدد كبير من رواياتهم من التصنيف الروائي، بينما تعامل معها النقاد كروايات.
التاريخ الأدبي العالمي، ونحن من ضمنه، شهد كسراً للنموذج على مر العصور، وهذا لم يقتصر على الرواية فقط، وإنما على الشعر، وإذا كان الأعمال السردية لا تزال تحتفظ بقوانينها وشروطها، ومن السهل التفريق بين القصة القصيرة والرواية والنص المفتوح، إلا أن الشعر لم يعد يحتفظ بشروطه وقوانينه الصارمة التي كانت سائدة في السابق، وأصبح يقترب إلى السرد النثري المليء بالبلاغة والبيان والمحسنات اللفظية، ولا تظهر هذه الفروقات والمعايير إلا في المسابقات الشعرية التي تطلب الالتزام بمعايير محددة، بينما في الشكل الحكائي السردي القصصي، لابد من وجود شخصيات وحبكات وأزمنة وأمكنة وغيرها، مهما ابتعد عن العناصر التقليدية للسرد.
كلمة نوفيلا غير مستخدمة في الأدب العربي، ومن النادر العثور على عمل مصنف كـ«نوفيلا»، والجميع يصنف أعماله السردية المتضمنة للعناصر القصصية بالروايات، ونعود فنقول إن الجوائز الروائية هي التي تحدد تلك الشروط وتطلب توافرها.
أعتقد أننا مازلنا في عصر القصة الطويلة أو النوفيلا، لكن هذا لا يلغي التصنيف (رواية) عن الأعمال، وبشكل مبسط، هناك راو يتحدث، إذاً، فهناك رواية.
موقف
عن موقفها الشخصي من النوفيلا تقول الكاتبة فتحية النمر: أنا لا أحب أن أكتب روايات قصيرة، والتي كتبتها كانت في بداية المشوار، بل إن «السقوط إلى أعلى» كانت أول عمل لي على الإطلاق، وعندما كتبتها ما كنت أعرف الفرق بين الرواية القصيرة والطويلة، ولم أكن أعرف أنني أكتب نوفيلا.
كانت عندي فكرة وعندي شخصية ملحة وأرق وهاجس للتعبير عن الضجيج الداخلي، هذا كل ما أعرفه. ومنها شرعت في الكتابة، أما لماذا جاءت قصيرة؟ فلا أعرف السبب، وعلى الرغم من أنها كانت قريبة من الـ200 صفحة لكنها قصيرة. والآن لا أحب أن أكتب روايات من هذا النوع! لأنها لا تشفي الغليل ولا تعيد التوازن ولا تحقق الراحة ولا تعمل على تطهير الروح من القلق.
الحب والوعي
يقول الروائي علي ابو الريش نحن كي نكتب الرواية نحتاج إلى شيئين، الحب أولاً، لأنه يجعلنا حقيقيين ومن دونه نبقى مجرد خيال وحلم لا يحتوي أي جوهر.
إنه يمنحنا الجوهر والنزاهة، والشيء الثاني هو الوعي وبين هاتين الضفتين يتدفق نهر الرواية ليأخذنا إلى الكينونة. فالرواية والكينونة مثل الموجة والبحر، هي منفصلة ومتصلة وكلاهما من قطرة الماء، كما أن الإنسان والرواية من نطفة الرعشة الأولى.