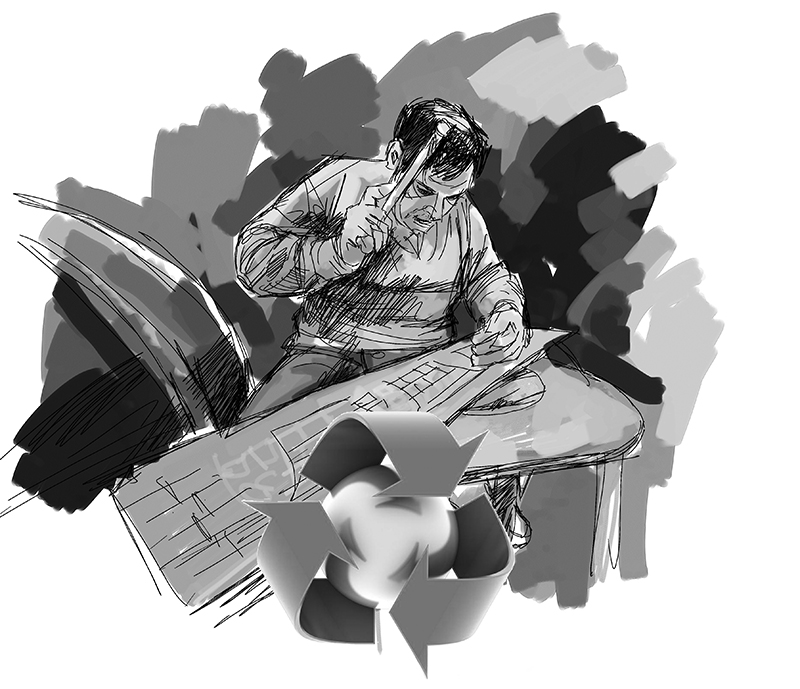مشهدان لفتا انتباهي ولم أكن أعرف تفسيراً لهما. رجل مسن يجلس ليلاً على زاوية الرصيف. أمامه كيس كبير، يخرج منه علب مشروبات غازية فارغة. بحجر يدق العلبة حتى تستوي بالكامل، يرتب العلب فوق بعضها ويضعها في كيس آخر. لا يتحدث مع أحد من المارة، ولا حتى يرد السلام، دائماً منهمكاً حتى أذنيه في عمله! كنت أتساءل: عمله؟ ماذا يعمل هذا الرجل؟
المشهد الثاني: سيارة نقل صغيرة تتوقف عند حاويات النفايات الصغيرة المنتشرة في أماكن محددة في الشوارع. يخرج منها شاب، وأحياناً السائق أيضاً، ينبشان الحاوية، علمت في ما بعد أنهما يبحثان عن ما يمكن «إعادة تدويره» من علب وزجاجات فارغة ولا أدري عن ماذا أيضاً.
قالوا قديماً، وليس قديماً جداً، أن «قلة الشغل تعلم التطريز». اليوم يقولون إن انعدام الشغل يعلم «التدوير». والتدوير أو إعادة التدوير، يا سادة، أن لا تعود سلة المهملات مكاناً لإلقاء ما تعتقد أنه لا يلزم بل للاحتفاظ به، إعادة تدويره والاستفادة منه بأشكال متعددة ومختلفة عن الشكل الأصلي. فلم تعد «الحاجة أم الاختراع» فقط بل أم التدوير أيضاً.
ولمزيد من المعرفة، بحثت عن «إعادة التدوير» Recycling لأجد أنها مهنة محترمة سبقنا الغرب إليها، كالعادة بعشرات السنين. وتحديداً في ستينات القرن الماضي. وتتميز تلك الفترة بوجود طاقة أقل وتكلفة أقل. وبعد النجاحات التي حققتها إعادة التدوير في الستينات، جاءت فترة السبعينات بالعديد من الأفكار والاستثمارات من مصادر متعددة. كانت لا تزال الثورة الصناعية جارية والمجتمعات تسهم بجهد مشترك في المشاركة بالأفكار والحلول وبعد وقت قصير أدرك العالم أن الصناعيين هم من يمتلكون مفتاح الوصول لمستقبل أكثر تطوراً في مجال إعادة التدوير وذلك عن طريق تطوير المنتجات التي تسهل معالجتها وصناعتها من مواد معاد تدويرها. فهمت تلك الشركات أن المنتجات الجديدة تستهلك طاقة أقل وذلك سوف يوفر لهم بعض التكاليف وتمدهم بسبب واضح للتغيير وتحقيق مكاسب مالية أكثر. إضافة إلى كونها صديقة للبيئة.
فاجأني هذا العالم الغريب عني، أو بكلام أدق الذي كنت أنا غريباً عنه وهو حولي وعلى بعد بضعة شوارع مني. حدثت صديقي عن «الاكتشاف العظيم» الذي توصلت إليه عن «إعادة التدوير» وعن معرفتي بسر ذلك الرجل الذي يجلس على الرصيف ويدق العلب الفارغة.
ضحك صديقي حتى كاد يقع على قفاه. ظننت أنه لم يصدق ما قلته. قال وقد اغرورقت عيناه بالضحك: وهل الآن عرفت عن إعادة التدوير؟ قلت بدهشة طفل: نعم، الآن. قال: تعال معي. أخذني بسيارته إلى منطقة صناعية قريبة من العاصمة. على طول الشارع الذي يفصل بين قسمي المدينة، كان ثمة محلات كبيرة أشبه بالورش، مغطاة بالزينكو، على مداخلها أكوام مرتبة من قواعد خشبية. علمت في ما بعد أنها تلك القوالب التي توضع فيها الأجهزة الكهربائية الكبيرة كالثلاجات والغسالات التي يتم شحنها بالسفن من دول أمريكا وأوروبا والصين واليابان لتحافظ عليها حتى لا تتكسر.
قال صديقي: هذه نسميها «طبليات» وهي رخيصة الثمن. يشتريها الناس ويعيدون تدويرها ليصنعوا منها مقاعد وطاولات وأكشاكاً، كما يستخدمونها في الحدائق كبيوت للدجاج والحمام والحيوانات الأليفة بعد أن يطلوها بالألوان التي يريدون.
ضحك وقال: سأزيد دهشتك. قلت: هات ما عندك. قال: هل رأيت الطابق الثاني الذي بنيته فوق منزلي الريفي أخيراً؟ قلت: نعم، جميل جداً. قال: أغلبه من هذه «الطبليات»، الجدران، المقاعد، والسرير. قلت، مندهشاً طبعاً، حتى السرير؟!! قال: نعم، السرير وحتى الثريات المعلقة بالسقف والتربيزات وإطارات اللوحات الجميلة، كلها من خشب هذه «الطبليات».
ثمة عوامل تدفع باتجاه هذا النمط من إعادة التدوير أولها الركود الاقتصادي الذي ضرب العالم في 2008، البطالة، انخفاض معدلات النمو.. وما خلفته جائحة كورونا من آثار سلبية على الدول والشعوب.
الخشب ابن الشجر، الشجر بيته الغابة، إنها العودة إلى الغابة أيها السادة!
كاتب أردني*