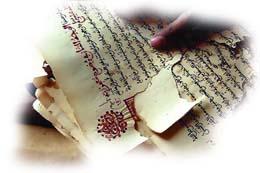في العام 1977 قررت الدول العربية مجتمعة إقامة المعهد الثقافي الإفريقي العربي، وظل هذا المشروع يتأرجح حتى بدأ نشاطه في باماكو سنة 2002، سنوات طويلة تعكس أحيانا البطء العربي الإفريقي في التعاون والحوار، لكن صدور كتاب «مخطوطات اللغات الإفريقية بالحرف العربي» جاء ليعيد التواصل بين الثقافة العربية والثقافة الإفريقية مرة أخرى.
الكتاب صدر بثلاث لغات هي العربية والفرنسية والانجليزية، وهو يعكس مدي تجذر التأثير العربي في إفريقيا، الذي تأثر سلبا بالاستعمار، ثم بعدم وضوح الرؤية العربية في التعامل مع إفريقيا. كتبت العديد من اللغات بالحرف العربي مثل المالاجاشية والسواحيلية والهوسا والولوف والسنغاي وغيرها كثير.
يتألف الكتاب من ثمانية فصول، يقدم من خلالها العديد من المخطوطات الإفريقية المكتوبة بالحرف العربي مثل مخطوطات اللغة المالاجاشية التي سادت مدغشقر، والتي كانت تعرف باسم مالاجاش حتى فرض الفرنسيون اسم «مدغشقر» على الملك راداما الأول مطلع القرن التاسع عشر عندما وقعوا معه العديد من الاتفاقيات وقدموا له أختاما باسم مدغشقر عام 1819م.
والتي سماها العرب منذ فترة مبكرة باسم «جزيرة القمر الكبيرة» كما هاجر إليها العرب ومهاجرون من إندونيسيا وماليزيا، فضلا عن هجرات من الساحل الشرقي لإفريقيا. والمالاجاشية لغتها خليط من لغات عدة آسيوية وإفريقية فضلا عن العربية، وانتشرت كتابتها بالحرف العربي، اختار معد الكتاب ليعبر عنها مخطوط تاريخي يحكي مرحلة من تاريخ مالاجاش يعود للقرن الـ 19 صدرت له دراسة أعدها لودفيغ مونتي، المخطوط يقع في 73 صفحة نشر منها في هذا الكتاب 18 صفحة.
ويذكر مونتي أن هناك سبعة آلاف صفحة من المخطوطات المكتوبة بالمالاجاشية ذات الحرف العربي في المكتبة الأكاديمية بالنرويج. أما اللغة الثانية التي تلفت الانتباه في الكتاب فهي السواحيلية، هذه اللغة نسبت للساحل الشرقي لإفريقيا حيث حدث تزاوج ثقافي إفريقي عربي مبكر، وانتشرت اللهجة السواحيلية في تنزانيا، كينيا، أوغندا، الصومال، جزر القمر.. الخ.
ومن المخطوطات التي كتبت بالحرف العربي السواحيلي قصيدة الانكشاف، التي تعد من أقدم نصوص اللغة السواحيلية الراسخة، كتبها عبد الله بن ناصر الذي عاش ثمانين عاما بين 1720 و1820 في جزيرة باتي على الساحل الكيني، تتضمن القصيدة 79 بيتا وفق نظام الشعر العربي «الرباعيات» وهي مكتوبة بلهجتي لامو وممباسا.
ومن اللغات الإفريقية التي كتبت بالحرف العربي الهوسا وهي من العائلة اللغوية التشادية، التي امتد استخدامها حتى نيجيريا وعدها البعض لغة تعامل تجاري في أسواق غرب إفريقيا لأنها بدأت كلغة مشتركة في مناطق توقف قوافل التجارة. وقد دار جدل واسع في الجامعات الإفريقية حول هذه اللغة كواحدة من اللغات التي قد تعبر عن طبيعة إثنية أو ثقافية أو سياسية حيث استخدمت كلغة رسمية لبعض الممالك في غرب إفريقيا.
ويعبر ثراء لهجات الهوسا الآن عن هذا التاريخ الغني بالثقافة وحركة المجتمع بما يجعل التميز الواضح في اللهجات، تميزا في طبيعة التاريخ الاجتماعي نفسه. فلهجة كانو «للثقافة والتجارة، وسوكوتو الكلاسيكية للنصوص الدينية التقليدية و«زندر» و«جوبير» عابرة للصحراء، و«داجومبا» لهجة ذات محلية خاصة.. إلخ.
ومن هذه الأجواء جميعا انطلقت «كتابة الهوسا»، من عوامل التوحيد الرئيسية في المنطقة، الدين والتجارة، وكلاهما لم يستقر في المنطقة قبل القرن الثاني عشر الميلادي ولذا يجري الحديث عن أدوار علماء الإسلام الوافدين أولا لتعليم الدين، واستقرارهم في «كانم وبورنو» ثم في «كانو»..
وغيرها أمثال عبد الكريم المغيلي وغيره، أتاح ذلك الكثير من آثار التراث العربي الإسلامي إلى أن بدأت الكتابة بالعربية أيضاً من قبل علماء الإسلام المحليين، استغرق هذا الانتشار أكثر من عدة قرون حددت بين القرنين الثاني عشر والسادس عشر الميلاديين حتى بدأت الكتابة «بالهوسا» بالحرف العربي أو ما يعرف «بالعجمي» يكون لها السيادة على يد أمثال محمد بللو وغيره، وهنا تنوعت بين الديني والتاريخي والوعظي، وبين ثروة في الشعر في معظم هذه المجالات.
وتتعدد مواقع مخطوطات لغة الهوسا بشكل لا يكاد يتوفر لتراث أيه لغة أخرى، كما توفر لها من الدارسين ما يصعب حصره. ويستطيع الباحث أن يعاين هذه المخطوطات بالخط الكوفي وغيره في «سوكوتو» و«كاتسينا» و«كانو» و«زاريا» و«مايدوجوري» بل وايبادان.. ويحتل بعضها شهرة كبيرة وخاصة ما توفرت له ظروف الحفظ في هذه المواقع.
لعل هذا الانتشار للغة الهوسا - ومخطوطاتها - هو الذي جعل البعض يلاحظ أنها لم تتدهور أبدا كلغة، ولم يقل ان لم يزد دائما - المتحدثون بها في أنحاء مختلفة من غرب إفريقيا، وان كتابتها بالحرف العربي الأساس في ثباتها حتى ظلت تقاوم حتى الآن. تقوم جامعات أحمد وبللو «زاريا» وبابييرو «كانو» وعثمان بن فوديو «سوكوتو» تقوم بدور رئيسي في هذا الصدد حيث تعترف بالهوسا لغة جامعية يمكن إعداد الرسائل العلمية بها.
كما تعتبر أساسا لمشروع نشر تاريخ شمال نيجيريا. لكن الكتابة بالحرف العربي أصابها الكثير، ولكن ليس الموت النهائي، فقد حاول الإرساليون منذ أواخر القرن التاسع عشر كتابة نصوص جديدة من الهوسا بالحرف اللاتيني. وحين جاء كابتن «لوجارد» كمسؤول استعماري عام 1900 وجه الكوادر الإدارية أولا لتعلم لغة الهوسا ونصوصها العجمية.
ومن النصوص التي قدمها الكتاب بالهوسا: نص شفاهي تم تدوينه أوائل القرن العشرين عن أصل شعب الهوسا. ضمنه «راتراي» الاداري الأنثروبولوجي الإنجليزي في كتابه عن فولكلور الهوسا الصادر بلندن عام 1913 وأعيد نشره 1963 والنص قيمة علمية للدراسات الاجتماعية والتاريخية تتشابك فيه الوقائع بالتاريخ الاجتماعي.
كما ينطوي على نصوص لأحكام (في شكل مراسلات) تعتبر فتاوى عن مسائل اجتماعية تتعلق بالملكية والمعاملات وهي من مكتبة سوكوتو. وقيمتها واضحة للدراسات الاجتماعية وتطورها في نيجيريا. ومازالت صراعات مثل التي شهدناها في داجومبا بغانا عام 1995 تقوم على مثل هذه العلاقات القديمة.
يضم الكتاب نصا يمثل الذاكرة الاجتماعية لشاهد على «حرب المهدية» في السودان يسجل حضور أبناء الهوسا في فضاء بلاد السودان الواسعة وقد ضمنه تشارلز روبنسون في كتابه عن «علم النحو الهوساوي».. والنص يخدم عملية التأريخ من وجهة نظر شعبية لا تخفى قيمتها.
يعد الكتاب بصورته هذه ليس سوى بداية لاستعادة الموروث الثقافي المشترك بين العرب وإفريقيا، فمازالت حركة القبائل العربية في إفريقيا والعلاقات التجارية العربية الإفريقية، فضلا عن الحقب التاريخية التي سبقت الاستعمار الغربي، في حاجة ماسة لمزيد من الدراسات بعيدا عن نقطة الانطلاق الرئيسية التي تبدأ بالاستعمار الغربي.
د. خالد عزب
*الكتاب:مخطوطات اللغات الإفريقية بالحرف العربي
*الناشر:المعهد الثقافي العربي الإفريقي ـ القاهرة 2007
*الصفحات: 540 صفحة من القطع الكبير